كيف قَبِلَ المسلم على نفسه أن يكون ذليلا؟ ذليلا أمام أعدائه وشيطانه ونفسه ورزقه! إن الطمع هو السبب الذي يؤدي إلى المذلة! الطمع في غير مطمع، واختلال الميزان فيمن يطمع الإنسان. والكارثة أن الإنسان طمع بمخلوق مثله ولم يطمع بمن بيده ملوك كل شيء!
وهذا ينطبق على الأفراد والجماعات والدول.
الطمع في الإنسان الذي مثلك سببه خلل في العقيدة والتوجه، فلو علمت يقينا أن الله هو الرزاق فسيكون طمعك فيما عنده، ولو علمت أن الله يعز من يشاء ويذل من يشاء لما قبلت أن تذل لمخلوق آخر مثلك. فالخلل يقع في الوهم الذي هو نقيض اليقين!
مثال شائع بين الناس، بنت متدينة من عائلة متدينة وبلغت سنة الزواج، فخشية منها ومن رفقاء سوئها الذين يقولون لها: أنت إن تحجبت فسيفوتك قطار الزواج، صدقت هذا الوهم، ولو أدركت أن الله هو الذي يسوق النصيب لما التفتت إلى هذا الوهم، وهو وهم!
مثال آخر، رجل غني، فيدخل عليه الشيطان المدخل القائل: هل تعلم أن مبلغ زكاة مالك سيعيق كل خططك التنموية فدعك من هذا كله! أدخله الشيطان في وهم مضاد لفريضة، أمثال هذا سهل عليه أن يكون طماعا وذليلا! لماذا؟ لأنه لم يدرك يقينا أن الزكاة معناها النماء والبركة والزيادة، سيطر عليه والوهم!
مثال آخر، رجل ذهب إلى أوروبا ليشتغل، ودخل محلا تجاريا فوجده يبيع لحم خنزير ومشروبات، فيأتيه أحد شياطين الإنس فيقول له: الأحكام تتغير مع الزمان والمكان، فما عليك، ولو أنه أدرك يقينا أن الرزق بيد الله، وقصد الله في باب آخر “ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب”.
مثال آخر، أقبلت منذ صغري بتوجيه من والدي رحمه الله على العلم الشرعي والقرآن والأذان والصلاة والأوراد قبل أن أصل في مداركي إلى معنى الحياة، ومتطلبات الحياة، وقبل أن أعرف أطماع الدنيا. وكنت أسمع كلما تقدم بي الأمر نحو جدية الحياة، وقد تربيت على هذه الأوراد التي تقرؤون، وسماع القرآن وتلاوته، وعلى حب الدين، وحب الإيمان، وحب العمل لدين الله، هذا غرسه والدي فيّ منذ نعومة أظفاري… تُسمعني شياطين الإنس كلاماً من مثل: ماذا ستصبح عندما تكبر؟ مؤذن جامع؟! إمام جامع؟! أم مغسل أو ملقن موتى؟! هل ستصبح عالة على إخوتك؟! حتى عندما تعيّنت إماما، فما أكثر من عيّرني بهذه الوظيفة! وأنا لم أفكر في يوم من الأيام في حمل همّ الرزق، هكذا كان غرس والدي الشفوق الحنون فيّ، وكان يمكن أن يفكر في مستقبلي ومستوى معيشتي… لا أذكر أنه في يوم من الأيام ذكّرني بشيء يومئ ولو على استحياء بأمر الرزق، لا أذكر! وحملت هذا اليقين القائل: لو أنّ خدمة ديني ستوصلني لأن أكون كنَّاسا في الشوارع لرضيت. عُيّنت إماما فجاءني من يعيّرني، أتريد أن تمد يدك إلى الناس؟! وعند زواجي، إمام! كيف ستعيش بهذه الوظيفة؟! ولم ألتفت لهذا كلّه ولا حرّك فيّ شيئاً. صرتُ إماماً براتب، فأصبحت في صلاتي، ومن نتائج الغرس الذي غرسه فيّ والدي رحمه الله، أقول لنفسي وأنا أقف في الصلاة: كم تقبض جرّاء هذه الركعة التي تصليها الآن؟ فأصبحت أحسب وأقسّم راتب الأوقاف على الصلوات… فما عدت أقدر أن أصلّي! حتى استقلت، فعندما ذهبت إلى المديرية، والوظائف عزيزة عند الناس، فزع المدير واستنكر أن أترك عملي! ما هذا الجنون! عُد واذهب وفكر! لم أحسبها أبداً كما يحسبونها! والذين كانوا بالأمس يعايرونني، يعيشون في ضنك وشدة وتلبّسهم همّ الرّزق والوهم، أما العبد الفقير فأعطاني ربي، على غير ترتيب، لا منّي ولا من والدي، فلم يناقشني في يوم من الأيام في هذا! أكرمني أكثر مما أستحق، وما لم يكن ببالي! بل وأكرمي بأن جعلني ليس ممن يمد اليد سائلا، كما خوّفوني، بل أكرمني بأن جعلني ممن يمد اليد معطياً. وكل ما هددوني انقلب عليهم، وخلافه تماما انقلب عليّ. وهذا لا يعني ألا نأخذ بالأسباب، أخذت بالأسباب كما أرادها الله، لكن دون أن يخيفني الرزق ولو مقدار ذرة، لا ماضيا ولا حاضرا ولا مستقبلا إن شاء الله. وما اضطرت لأحد من خلق منذ أن استقلت، لكن يقيني بالله، وما جعل الوهم والطمع بما في أيدي الناس يدخل عليّ، وإذا بعطاء الله عز وجل كما ترون، له الفضل والمنة.
وفي المستوى الدولي، ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية ضربت ضربات قاتلة، لكنها لم تكسر الظهر بل قوّته، واليوم هما من أقوى اقتصاديات العالم. فالذي يأخذ بالأسباب وينجز يمده الله.
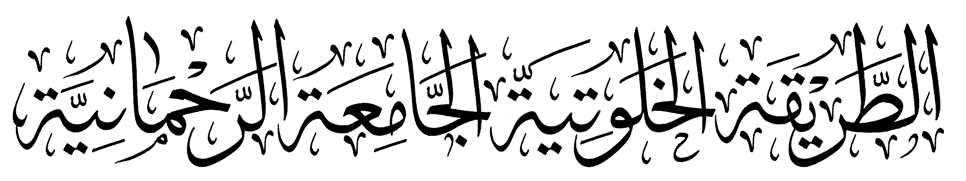 الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية زوايا الاشراف المغاربة
الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية زوايا الاشراف المغاربة


