وأنا طفل، كانت الأبوّة تحمل بالنسبة لي معنى الحماية، فأبي هو أقوى رجال هذه البسيطة، وان كان أبي راض، فهذا يعني أنني أتمتع بأعلى درجات الأمن، وإن كان أبي ساخط فهذا يعني أنني معرّض لثُلمات الحياة…
هذا شعور سائد ربما عند جميع الأطفال، ولكنه آنيّ، أي أن الطفل يشعر عند اشتداد عوده أنه ما عاد بحاجة لعنصر الحماية ذاك، أو أنه يعتقد أن الأمر قد انقلب وبات هو صاحب الحماية… أما عندي فما زلت بحاجة لحمايته، ولا أظنّني أستطيع الحياة بدونها…
يقولون، بأن كل فتاة بأبيها معجبة، فأنزعج لهذا الحصر، ولمّا يريدون توصيف شكل العلاقة بين الابن وأبيه يقولون بأنّ من شابه أباه فما ظلم! وكأنها توصّف سياقا سلبيًا… لا بأس ولكن اعلموا بأن نظرة حبّ من عينيّ أبي الكحيلتين كفيلة بتحويلي الى فتاة تكوّرت في خدرها اعجابا وحياءً من محبوبها، ونظرة تالية فيها عزم، كفيلة بتحويلي الى فارسٍ تنطوي له الأرض ليهوي بسيفه على رقاب مائة ألف أو يزيدون، وثالثة ربما تحمل عطف، كفيلة بقلب عدّاد الزمان لأرجع ذاك الطفل الذي لا يكفّ عن البكاء ليلًا إلا اذا أسند رأسه على كتف أبيه متنهّدا من فظاعة دنيا لم يعرفها بعد… لعينيّ أبي فعل لم يعرفه بعد من حصروا العلاقة ما بين اعجاب ومشابهة…
ويقولون ساخرين، بأن كل صوفيّ يرى في شيخه قطبا غوثًا، فأتململ، لأنهم بسطاء لا يُدركون معنى أن يجتمع لديّ مقام الأبوة والتزكية في شخص، ولا أدري كيف يطلبون منّي ألا أراه قطب دنياي، وغوث ما بعد مماتي…
يعترضون فيقولون، أنت متطرّف في الحبّ، ويحكم ! وهل كان الحبّ إلا تطرفًا، وهل يستوي بدون نزعة تُخرجك من انسانيتك لتقذفك الى ملائكيتك…
وإنما مثلي معه، كمثل مُتّهم جلبوه، وبالسلاسل أحكموه، والى الحائط أسندوه، ثم الى الجلّاد سيّروه، كان ذلك في يوم “زينة” ابتدعوه، فحُشر الناس وتنادوا أن اصلبوه، ثمّ شتموه وآذوه، حتى اذا تمكنوا منه وأوثقوه، وظنّ أنهم لا محالة مُهلكوه، طلع بدر من وسط الغوغاء صائحًا: ما الذي تفعلوه؟ الويل لكم ان لم تتركوه، أما علمتم أن له إليّ نسب وحسب قبل أن تظلموه، أم حسبتم أن يترك الأصل فرعًا دون أن يَحبوه، فكنت أنا هالكا لولا هو…
يا أبي، تالله ما خلق الله مثلك في الدنيا أجمعها…
بقلم: محمد حسني الشريف
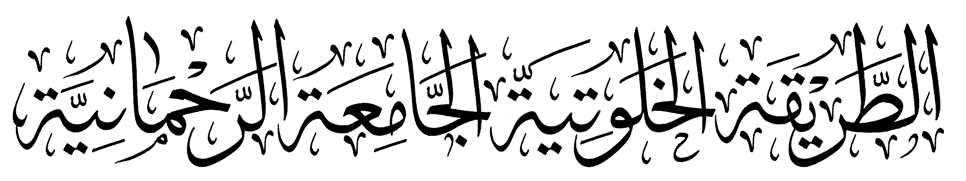 الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية زوايا الاشراف المغاربة
الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية زوايا الاشراف المغاربة


