لغة الحب، غيابها هو أحد أسباب مصائب أمتنا اليوم، بغيابها حلّت لغة الكراهية والبغضاء والشحناء والكراهية…
وبعد حديثنا الطويل عن الحب، فإن سؤالا يطرح نفسه وهو: كيف يأتي الحب؟ وكيف نتحقق من هذا المقام السامي؟ هذا المقام الذي تندرج فيه كل المقامات، فلا معارف يمكن أن تصل إليها من معارف وسنن الله إلا عبر بوابة الحب، فحب الحبيب موصل يا عاني فأحببه يا هذا بصدق جناني… وهو سر الحياة …
درب الوصول إلى المعرفة يمكن أن يكون طويلا ويمكن أو يكون قصيرا، فيمكن أن ينقضي العمر كله وبالكاد أن تحصّل المراد، ويمكن أن يكون قصيرا بمعنى سرعة التحصيل من خلال الصدق الحقيقي في العلاقة مع الله، فالطريق لمن صدق وليس لمن سبق… فقد يكون جائزة تختطف بلحظة، بلمحة وصلحة صادقة تحصّله، … والدرب الثالث أن تفني العمر في تمثيل وادعاء المقام دون أن تحصّل منه شيئا! وحال هذا الأخير هو أحد أنواع السالكين الذي لا يفيد معه السلوك والذكر شيئا، تنظر إليه فتحسبه مقاما يزار!
كيف السبيل إذن؟ السبيل يكون من خلال الذكر، فهو ما يوصلك إلى مقام الحب، والذي بدوره يفتح لك أبواب المعارف. لن تجد حاقدا أو غضوبا أو شديدَ كرهٍ يُفتح له باب من أبواب المعرفة، حتى وإن بقي يذكر الله صباح مساء، لا يفتر عن ذلك! فبغياب الذكر القلبي، ومع بقاء الذكر لا يغادر اللسان فلا فتوح! سدٌ أسود تصنعه الكراهية والبغضاء!
قلنا مرارا أن الذكر مراتب، ومن يظن أن الذكر القليل يؤدي لنتيجة فهو واهم! كل مرتبة من هذه المراتب يُقبل من صاحبها أن يَبقى في ذاك المقام حتى يرتقي للمقام الذي يليه، فلا ثبات! والحب إن لم يأت بصلحة أو بلمحة فسيفنى العمر في تطبيق المراحل التي سنذكرها، وبالكاد يتحصّل المراد! والذكر القليل هو ذكر المنافقين “ولا يذكرون الله إلا قليلا”، أما المؤمنون فذكرهم هو الذكر الكثير “يأيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا”.
يبدأ السالك بالذكر بلسانه، فيقرأ القرآن، ويسبّح، ويهلّل، ويصلي على النبي، …. جهرا وسرا، جماعة وفردا،… إن استمر هذا الذاكر على هذا الحال واستغرق عمره فيه من ذكر اللسان فيكون حاله حال العوامّ الذين لا يعونَ مدارج السالكين، وأدوات الوصول إلى المعارف الحقيقية، واللدنية الربانية، والعطايا الإلهية، والسنن الإلهية، … يعتقدون أن العلم وذكر اللسان هو كل شيء، وهذا غير صحيح، والدليل أن أصحاب هذا الشعار اليوم موجودون وممتلئون علما، ويذكرون هذا الذكر القليل، وبغير حضور … والأيام أثبتت شيئا من أحوالهم، من أحوال الكذب، والغيبة، والنميمة، وتحليل الدماء وسفكها، وشهادة الزور، والافتراء على الناس، والقيام بدور الإله، فيحاسبون الناس، علماء وأشباه علماء، وعند نقاشهم بقول الله ورسوله، يردّون عليك بكلام ينقلونه عن الشيخ فلان! هؤلاء ليسوا بعارفين، قال تعالى “وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون” قال ابن عباس: يعبدون أي يعرفون، فالعلم تبدأ به لتعرف، وهذه هي المعرفة التي عرفها الذاكرون الله حقيقة… وإلا فما الذي جعل الإمام الغزالي، بعد أن تربع على أعلى مرتبة علمية، في المدرسة النظامية، ما الذي جعله يترك كل هذا وراءه؟ عرف أن كل ما وصل إليه ما هو إلا علم لم يجده معرفة، فهرب إلى المعرفة، ليضع لهذه العلوم قياسا معرفيا لتوصله إلى الله عز وجل، ففرّ إلى الله “ففرّوا إلى الله”. أما العالم الذي يبيح الدماء فهذا لا يعرف الله، لا يعرف أن الله قد أحب خلقه، برّهم وفاجرهم، رزقهم وأعطاهم جميعا، ويوم القيامة يحاسبهم… ونحن نحب هذا الخلق ولا نعادي إلا من عادانا واعتدى علينا، نحبه لحب الله له، فهم نظراء لنا في الإنسانية. فهذا عالم وليس بعارف، وعلمه حجة عليه. سيدنا عمر عندما عطل حد السرقة “والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما…” هو يعي ويفهم ماذا يريد الله عز وجل من هذا الحكم.
ثم يأتي بعد ذلك ذكر القلب، وهو أن تتكلف الحضور، فبعد عمل اللسان في الطرق على القلب، ومن دوام قرع باب أوشك أن يفتح له، … فُتح الباب ودَخَلْتَ على ذكر القلب بكل أشكاله. هذا القلب الذي دَخَلَتْ عليه المعاصي قد تأثر بالصدأ والران الذي غشيه “إن هذه القلوب تصدأ ولها جلاء، وجلاؤها الذكر”، جاء صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له، يا رسول الله: كثرت عليّ شعب الإسلام، فدلني على عمل أتثبت به، فقال له: اجعل لسانك رطبا بذكر الله. ولأن هذه القلوب غير جاهزة فلا بد من تكلف الحضور! فمن جلس في مجلس الذكر وهو شارد الذهن، في الأولاد وفي العمل، وفي الرزق، …. فإذا كنت في مجلس الذكر وشردت فحاول لم شعثك وإعادة الحضور، هذا هو تكلف حضور القلب، القلب الذي عليه دور ومهمة كبيرة.
والذكر حالة تراكمية مع الفهم، كما الإيمان، أما الهذرمة في الذكر دون حضور ودون فهم، فلا تنفع في السلوك، صحيح أن الله لا يضيع لك أجرا، لكن هذا لا يجدي في حالة السلوك!
ثم ننتقل في مرحلة ثالثة إلى ذكر السر، وهو تكلف الصرف أو الانصراف، بعد أن كنا في تكلف الحضور! أي أنك لا تستطيع الخروج من حالة الذكر إلا بعَنَتٍ ومشقة! وهذا مطلوب، ويمكن أن تصل إليه، ولكن ما هي متطلباته؟ لا بد من العمل فيه استعدادا لمرحلة رابعة، وهي سر السر، أن تبدأ بالتخلص من أعبائك وحملك، من أثاثك وأغراضك، حالة الفرار إلى الله، وليس بالضرورة في عالم الواقع، ولكن في عالمك أنت! بمعنى أن تسقط من عينك كل متع الحياة، فلا تعود لها قيمة عندك، وتبدأ بالتدرب على ذلك، وقبل ذلك لا بد أن يكون قد سقط من عندك أمور أخرى عند مرحلة الحضور، منها: الكذب، والحقد، والضغينة، وكثرة الكلام وفضوله، والشتيمة، والكراهية، والعنصرية، والطائفية، وحب الدنيا والمال والولد، والتنافس في الحياة، …. كل هذه المتعلقات، إذا ما حضرت الوفاة فإن الروح تتعذب في خروجها لشدة تعلقها بهذه الشهوات، فتنتزع نزعا، لكن روح المؤمن، الذي تخلص وتنظف من هذه الأغلال، فعند خروجها تخرج بسلام… هل من عاقل يرى أننا قد نصل إلى مقام ذكر القلب مع تكلف الحضور (قبل الحديث عما بعده من المعرفة) وكل هذه العيوب موجودة فينا؟! هل يمكن لعاقل أن يتصور أن عاقّا لوالديه يمكن أن يحصل شيئا من هذه المقامات؟! كيف تريد من الله أن يعلّمك وأنت تخالف أمره صراحة، جهارا نهارا؟!
لا يعتبن أحد له 10 سنوات أو 15 سنة من الحضور والذكر وقلبه ما زال قاسيا! هذا ليس بذكر! لا ذكر مع الكره، ستبقى تراوح مكانك! لا بد أن تخرج من أطوار نفسك وتتخلص من عيوبها، وتبدأ بحالة الفرار إلى الله.
نحن الآن في مرحلة الذكر مع تكلف الانصراف، ونحن هنا لا نريد أن ندعو إلى حالة الفرار التي كانت عند بعض ساداتنا، ولكني أدعوا إلى التوطئة لها، أو أن نكون في قلوبنا هاربين عن الدنيا، متخلصين منها، مستعدين للقاء الله عز وجل، حتى وإن كان الظاهر أننا نقوم بواجباتنا تجاه أبنائنا في تربيتهم وتعليمهم … ولكن في داخلك أن تعمل لله فقط، وإذا وصلنا لهذه المرحلة نكون قد دخلنا في مرحلة سر السر، وهو لب اللُّباب، وهو حالة الفناء المطلق، بأن ترى الله في كل شيء، ولا ترى سواه! هذا هو السلوك، أن تنكسر على باب الله…
سيدنا داود عليه السلام يسأل الله فيقول: أين أجدك، فيقول له: عند المنكسرة قلوبهم لأجلي، كل يوم أدنو منهم باعا، ولولا ذلك لانهدمت قلوبهم من الشوق.
هذا هو السلوك، تسير فيه على محطات، وفي كل محطة استحقاق من الاستحقاقات وعمل، فلا تأتي قيامتك إلا وأنت جاهز ونظيف للقاء الله عز وجل. “ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين”. هذا هو الذي جعل الإمام الغزالي يفرُّ إلى الله بعدما وصل أعلى مراتب العلم، أسقط كل الملذات والمتع والشهوات، …
سيدنا إبراهيم بن أدهم، أحد ساداتنا، هو أمير فارسي، صاحب صولة وجولة وخدم وحشم، … كان في يوم يسير وهو في موكبه، وإذا بهاتف من قلبه إلى أذنه يقول: “ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر”، فتوقف ونزل عن فرسه وتأمّل، فأجاب: بلا يا رب، وغالب الظن أن من يأتيه هذا النداء يكون قد قطع أشواطا، فخلع ملابسه، ملابس الإمارة والعز، ولبس لباس أحد الخدم، وهام على وجهه، وفرَّ إلى الله، وترك كل العز والجاه… بعد مدة ذهب إلى بيت الله الحرام، وأثناء طوافه بالكعبة شاهد فتى، وظل ينظر إليه، ثم جلس حزينا فسأله أحد أصحابه عن حاله، فقال: أترى ذاك الفتى، هو ابني، اذهب وسلّم عليه وقل له: أبوك يسلّم عليك، فجلس يبكي ويقول: هجرت الخلق طُرَّاً في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، ولو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك.
هذه هي حالة الوداع والفرار الكامل إلى الله، ولا يجوز أن ننطلق في السلوك بوتيرة واحدة، فلا تطمئن إلى نمط واحد، لا بد من العمل حتى إذا دنت النهاية تكون جاهزا.
في علم السلوك وقراءة تاريخ أهل السلوك، هناك أحد طريقين لا ثالث لهما، الأول: وهو الطبيعي المطلوب، وهو أن يسير السالك في هذا الدرب حتى نهاياته، ويتدرج حتى يصل إلى مراده من المعرفة، ويمكن خلالها أن تأتي له لمحة صدق مع الله مفجرة تجعله يقطع العوالم في لمحة. أما الطريق الثاني: فهو حالة من ركب موجة أهل السلوك، فلا هو فهم ولا هو صدق، وأنا هنا أبرئ ذمتي ممن يسلك ولا يفهم، ولا يستفيد، ولا يصدق، ولا يسعى للتخلص من عيوبه وآفاته، هذا النوع هو من أهل الهذرمة، إذا وجد إخوانه من الصادقين في حالة الترقي والتخلص من العيوب وارتقاء الأحوال، وهو لم يصدق كما قلنا، فيدخل عليه إبليس فيضيع عليه دنياه وآخرته من خلال ادعاء المقام بالكذب والتمثيل في المقام! فإما الكذب أو الهروب عند أصحاب هذا النموذج.
الخلاصة أنه لا باب إلا باب الله، نظل على بابه نطرق ونصدق، فيفتح.
نسأل الله أن يبصرنا بعيوب أنفسنا، ونسأله أن يخلصنا من آفاتنا، وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان.
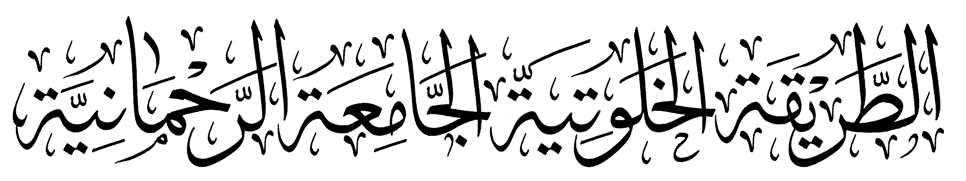 الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية زوايا الاشراف المغاربة
الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية زوايا الاشراف المغاربة


