إن لله صفات جلال وصفات جمال، صفات الجلال تدل على بطش الله وقدرته، كما في قوله (إن بطش ربك لشديد)… وصفة الجمال تدل على رحمة الله وعفوه، كما في قوله (ورحمتي وسعت كل شيء)…
ومن الناس من يأتي بالخوف، ومنهم من يأتي بالترغيب واللين. والحال هنا كحال مريض السكري، إذا انفرد بنفسه وبالحلويات، فإذا رآه أهله خاطبوه بإحدى اللغتين: إما التخويف بعاقبة هذا السلوك فيكف عن الخطأ، أو بالترغيب بلغة رقيقة.
إذا غلبت على السالك، من خلال سلكوه وأوراده وذكره لله عز وجل، وسيره مع أهل الله، إذا غلبت عليه صفات الجلال فيكون حاله حال قبض، وحال القبض هذا هو حال كثير من حديثي التوبة.
أما الناس التي يغلب عليها أثناء سلوكها صفات الرحمة والأنس بالله والثقة بالله وحسن الظن به، نسمي حالهم حال بسط.
وهكذا يأخذ الله عباده بالتربية، فإذا غلب على العبد حال القبض ووصل إلى مرحلة اليأس، أخذه من حال القبض إلى حال البسط، فيغلب عليه حال الأنس. وإذا استمر حال الأنس هذا فسيأخذه إلى حالة من التثبيط في الطاعة والفتور، فيختلط عليه مفهوم الأنس مع مفهوم التمني والتألّي فيفر ويأمن. يبقى هكذا في حالة التقلب هذه بين مقامي القبض والبسط.
ومن الآيات الدالة على هذا التقلب (يوم نقول لجهنهم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) ثم يأتي بعدها الآية (وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد)، هذا التجاور في الآيات يحمل معنى التداول في المقام.
والسؤال هنا: هل يبقى السالكين متقلبا هكذا بين هذين المقامين؟ الجواب: لا يبقى، فهي مرحلة مؤقتة، وعلى السالك أن ينتقل إلى مرحلة أرقى مع الله، هي مرحلة الحب الذي نبحث عنه، وهي أصل العلاقة، فالله عز وجل ينقلنا ما بين خوف ورجاء حتى يوصلنا إلى المعنى المنشود.
وفي هذه المحطات، يقول ﷺ “أحبوا الله لما يغدوكم به من نعم”، فهذه وسيلة في التدرج حتى الوصول إلى الهدف. بمعنى كيف لك أن تحب الله؟ بأن تستحضر نعمه وعطاياه.
ولم التنقل ما بين المقامات؟ حتى تصفو له وحده، وللخروج من سلبيات كل مقام (اليأس من جهة القبض والفتور من جهة البسط). قلبك بين المالك وهو أغير منك يا سالك، يريدك له، ولا يريد لك أن تشرك معه شيئا، هو وحده، حتى وإن كانت نعمه! (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون). ولذلك تجد في دعاء البعض لله لا تجده يتخذ من الدعاء وسيلة صحيحة في العلاقة مع الله، وعندما يقرأ القرآن يقرؤه بغرض أن يرزقه الله، وهذا سؤال نتعرض له في كل يوم: ماذا أقرأ ليرزقني الله أو لكي لا يمرضني الله؟ الله لا يمرّض أحدا! انظروا أدب سيدنا إبراهيم مع رب العزة (الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين) ولم يقل الذي يمرضني! فالله يريدك بدون سبب أو علة أو مصلحة، لا خوفا من نار ولا رغبة في جنة، يريدك بعلاقة من أجل ذاته. وهذا هو ما نبحث عنه من مقام، تلك كانت مرحلة سابقة (قبض وبسط) لتوصلنا إلى هذه المرحلة.
ما عبدتك طمعا في جنة ولا خوفا من نار وغنما عبدتك لاستحقاقك العبودية لذاتك، هذه هي أصل العلاقة، دع ما ترد إلى ما يريد، ما لك إرادة، فهي حب مجرد عن الأغراض. تثاب على قراءتك للقرآن طلبا للرزق ولكن ليس هؤلاء هم الصفوة، المقام الذي نتحدث عنه هو مقام أهل الله وأوليائه (هكذا دون أغراض، وإن كانت الجنة).
تذكرون ثوبان، جاء إلى رسول الله يبكي، ما بك؟ قال: حبك يا رسول الله، أكون في أهلي فأذكر الجنة، وفي المقام أنت مع النبيين، وأنا في آخر الجنة، فكيف أراك؟ أكون في بيتي فأهيم حبا، وآتي إليك فيسكن قلبي…. انظروا إلى المعنى: شغله حب الرسول ﷺ ومشاهدته والأنس به عما في الجنة، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نزلت في حقه آيات تتلى لتسكين قلبه (ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين …) المعية “أنت معه”.
هكذا هي العلاقة، وانظروا إلى بعض المسلمين الذين يلتزمون الدين ليصبح لهم قيمة بين الناس! كم هو بعيد هذا عن مقامات أهل الله؟! يتزيى بزي أهل الله لينال التوجيب والتوقير من الناس! وليس في حسابه مراقبة الله! وكذلك من يلتزم لينصب على الناس، وليسيّر تجارته، وليذيع صيته، كم بعيدون هؤلاء!
تذكرون سيدنا بلال وعذابه في رمضاء مكة، حيث يذوب شحم ظهره على الأرض، وهو يقول: أحدٌ أحد! قد يظن البعض أن “أحدٌ أحد” شكوى، وأأكد لهم بأنها متعة جعلت قيمة الحب الإلهي عند سيدنا بلال تطغى على مرارة الألم! أين حسابات الدنيا والربح والخسارة والجنة والنار، المسألة أعلى من هذا بكثير! هذا العبد الذي عرف كيف يحب ربه، أهّله هذا لأن يختاره الرسول ﷺ من بين أشراف الناس عربا وعجما، جاهلية وإسلاما، يختاره في يوم الفتح ليطأ بقدمه الشريفة أشرف بقعة على وجه الأرض، عندما صعد على ظهر الكعبة ليؤذن، هذا إنسان ربّاني، وليس إنسانا عاديّا!
ورد في شرع من قبلنا أن البحار تستأذن ربها كل صباح: دعني أغرق العصاة، والسماء تستأذن ربها أن تطبق على العصاة، والأرض تستأذن ربها أن تنشق فتأخذ العصاة، فماذا يقول لهم الله عز وجل: هؤلاء أنا خلقتهم، ولو خلقتموهم أنتم لما طلبتم هذا! ألا ترون أنه يرزق البر والفاجر! فهو يحب الكل! ويريد حبا بلا واسطة ولا سبب!
جاء رجل حبشي إلى أحد أولياء الله في الحجاز، فقال: يا هذا أنا عاصي، فهل لي من توبة؟ قال نعم، إن تبت وصدقت لك توبة. فخرج الرجل فرحا، وعاد بعد حين يسأل هذا الولي: هل كان يراني عندما كنت أعصيه؟ قال: (ألم يعلم بأن الله يرى)، نعم كان يراك! فشهق شهقة خر ميتا! في البداية كان همه الجنة أوالنار، فلما سكن قلبه واطمأن اهتم لأمر العلاقة مع الله وأهميتها فذهب ذهنه إلى التساؤل: أنا أعصيه وهو يراني؟! أنا أعصيه، وشري له صاعد، وخيره إلي نازل، أنا أعصيه وهو يسترني ويترك الناس تظن بي الظن الحسن! فلم يُطِق الأمر بعد أن وصل إلى المعنى الذي نقول! حب إلى الله بلا واسطة ولا غرض ولا هدف!
هذا هو مقام ساداتنا، ومقام من سلك معهم وصدق. والوصول إليه ليس صعبا، أوّله الفهم بأن نزول هذا الدين لم يكن لأجل استخدامه لمصالحنا، هذه مرتبة دون لا أقبلها لأحد، لا لنفسي ولا لكم! قد نقبل في مرحلة ما الخوف والرجاء والتقلب بينهما إلى أن تفهم، وعندها “ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب”.
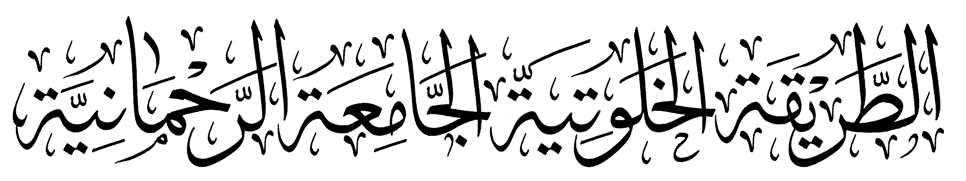 الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية زوايا الاشراف المغاربة
الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية زوايا الاشراف المغاربة


