هذا أوان إعلان الفقر والمسكنة والانكسار على أعتاب الله، بعد أحد عشر شهرا قضيناها نلهث في الدنيا ونعرض عن الآخرة، هذا وقت الافتقار والأوبة والتوبة لله عز وجل، طلبا لرحمته ومغفرته، وتعطشا لنفحاته. وإذا لم يكن الفقر والمسكنة فلمن الصدقات؟! ألم يقل الله “إنما الصدقات للفقراء والمساكين”، فلنكن من هؤلاء حتى يتصدق الله بها علينا في مواسم الرحمة التي نحن على أبوابها… “يأيها الذين آمنوا أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني”… فقراء نطلب الصدقة، مساكين نطلب العطف والتلطف من الله… ويصدق فينا قول الله “رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير”.
هذا أوان المسكنة ويكفي فرعنة.
ما الذي أصاب مجتمعاتنا في هذه الأيام؟ اللغو القائم الآن غير مسبوق، دعونا ندخل إلى الصيام بمعنى جديد، نقاوم به هذا اللغو، وهذه اللغة غير المسبوقة، من الشتم، وفضول الكلام، والكراهية، والأحقاد، الذي لا يستثني أحدا (لا كبير ولا صغير، لا عالم ولا جاهل، لا مسؤول ولا سائل، …).
يأتي الصيام بمعنى الكف عن شهوتي البطن والفرج، قال تعالى “يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون”، وهناك في المعجم العربي ما يعرف بالصوم، وهو بمعنى الصمت، وما أحوجنا إليه، “فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا”. قال ابن عباس: الصوم هو الصمت.
ومن الصيام والصوم تتولد مرتبة الصائم، “إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم”، أي ليصمت، فكما أنه صائم عن الطعام والشراب فليصم عن الكلام أو فضوله. وليتنا نتلمس هذا المعنى في زمن الانفلات، قال تعالى: “إن المسلمين والمسلمات” (مرتبة الإسلام)، “والمؤمنين والمؤمنات” (مرتبة الإيمان)، “والقانتين والقانتات” (مرتبة الإحسان)، ثم يترقى في مرتبة ثامنة ليقول “والصائمين والصائمات” (وهو هنا ليس بمعنى الصوم الذي في مرتبة الإسلام، فقد سبق ذكره، وإنما هو بالمعنى الذي يحقق الصيام بمرتبتيه، صيام البطن والفرج وصيام اللسان)، …. وانتهى في المرتبة العاشرة بقوله “والذاكرين الله كثيرا والذاكرات”، فمطلوب أن نتحقق من هذه المرتبة، ونصوم بهذا المعنى، ونسأل الله أن يتلطف بنا وألا يحاسبنا بأفعالنا بل بما هو له أهل، وألا يجري علينا ما أجراه على عاد وثمود. ولعل في صيام نخبة من المسلمين بهذا المعنى دعوة إلى الله بأن يتلطف بالبقية، لأن مؤشرات التجاوز اليوم تتجاوز كل خطوط اللطف! ولو أن الصحابة الكرام كانوا بيننا لما سلم أحد منهم من ألسنتنا، وهذا الحال مصنوع صناعة ووقعنا فيه، وأسأل الله ألا يكون هذا مقدمة لشيء كبير يقع في أمتنا.
كنا نتكلم سابقا عن فضول الكلام “من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت”، أما اليوم فالدعوة هي إلى أن تكلَّمْ ولا تصمت، لكن اختر كلامك، وقل خيرا، واتق الله فيما تقول (من باب أقل الضررين).
سئل سيدنا عيسى عليه السلام عن نصيحة فقال: لا تتكلموا أبدا، فلما استصعبوها قال: لا تتكلموا إلا بخير.
يخشى ان نأتي يوم القيامة، ونحن نحسب أن في صحائفنا أعمال صالحة كثير، فنفاجأ بجبال من المعاصي مسجلة، ونجد عملنا الصالح قد جرى عليه قول الحق “وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا”. فكما أن “الحسنات يذهبن السيئات” فإن السيئات تحبط عمل الحسنات.
نحن في أمر خطير، وباب الله مفتوح فلا نقنط من رحمته. وأتمنى كل من يعي هذا الكلام وخطورته أن يبادر قدر المستطاع إلى توعية من هم في محيطه، ومن له تأثير فيهم “ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم”.
مجرد أن تَعرضَ مسألة على إنسان ينطلق لسانه بدون تفكير، وبدون أن يمر الكلام على قلبه أو عقله، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن لسانه خلف قلبه، والمنافق لسانه أمام قلبه. متى كنا كذلك، هل كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟!
فرصة لكف الألسن في رمضان بصيام الجوارح كلها… لتبديل الصفات، كنا ننادي للتغيير للأحسن فغيرنا للأسوء، وبقاؤنا في هذا الحال يجعل الله لا يبالي بنا بأي واد هلكنا.
وانظر إن كان الحديث في موضوع الشيعة، لا يسلم منه سيدنا أبو بكر ولا سيدنا علي، ولا سيدنا عمر، ولا أعراض أمهات المؤمنين، لم يبقى عندهم إلا التطاول على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام في جيلنا هذا، لا في صفين ولا الجمل، لم يسلم أحد من الشتائم، تماما كما في المثل العاميّ “الولد الطالح يجلب لأهله الشتيمة”.
ولا أدري بم نقبل على ربنا، لا جهاد، ولا اقتصاد وإنتاج، ولا تربية أجيال، ولا دين، بأي شيء ذاهبون؟! رحماك يا الله! وكأن الناس ما عادت تؤمن بآخرة ولا حساب ولا عقاب! وبالتالي غاب الخوف من الله. لا بد من جرد للحساب، ثم نقبل على الله بالفقر والمسكنة.
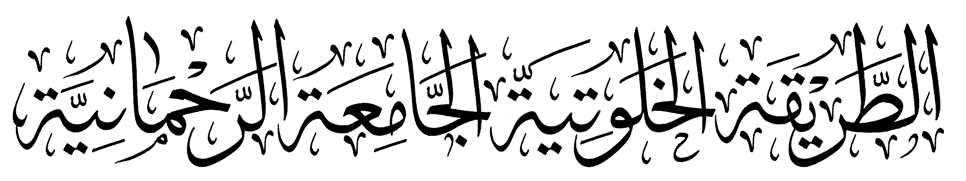 الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية زوايا الاشراف المغاربة
الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية زوايا الاشراف المغاربة


