أذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن السبب في إكثاره الصوم في شهر شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، وهو شهر ترتفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرتفع عملي إلى الله وأنا صائم.
من شأن هذا أن يدفع كل إنسان، بينه وبين الله خيط من الإيمان، إلى الرجوع إلى الله إن كان شاردا عن هديه، وإلى الاصطلاح معه إن كان معرضا عن أوامره، يتوب إلى الله من سيئاته حتى لا ترتفع إليه السيئات والمعاصي التي تثير مقت الله، والمُأمّل في هذه الحال أن تمحو الصالحات من الأعمال في هذا الشهر ما سلف قبل ذلك من الموبقات والآثام، مهما كثر، ومهما تطاول عليها الأمد، ومهما استمرت.
وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يهتم هذا الاهتمام في مثل هذا الشهر، ويعود فيحاسب نفسه ويراقب أعماله كي ترتفع صافية عن الشوائب إلى الله، وهو المعصوم عن السيئات والأوزار، فكيف ينبغي أن يكون حال أحدنا ونحن مغموسون في أيامنا وليالينا في الموبقات والغفلة، وما أكثرها.
إن ما يجري في هذا العالم من مصائب تنحط على المسلمين في مختلف أصقاعهم إنما هي من شؤمنا وشؤم معاصينا، وهو ما يؤكد ضرورة العمل على إصلاح الفرد المؤدي إلى إصلاح المجتمع حتى نكون أهلا لخلافة الله في الأرض.
ما ينبغي لنا أن نأخذ المناظير وننظر من خلالها إلى البعيد والبعيد، ونتحدث عن ظلم الظالمين، وعن سفاهة السفهاء وإجرام المجرمين، ثم نضع أنفسنا من ذلك في أبراج عاجية، بعيدين عن المسؤولية، وكأننا ملائكة نُظلَم ولا نَظلِم، يُساء إلينا ولا نُسيء، لو لم نُسئ إلى الله لما سلط الله علينا من يسيء إلينا.
روى الطبراني بسند صحيح (الظالم عدل الله في الأرض ينتقم به ثم ينتقم منه)، لماذا؟ لأن المسألة تعود إلى شؤمنا نحن، هذا الظلم نتيجة نسيج معاصينا التي تراكبت وتزايدت. ينبغي أن نعلم أنه بقدر ما تتفتح أبواب الرحمة الإلهية تتهيؤ وسائل الانتقام أيضا، فإما أن ننتهز هذا النداء الذي يبلغنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتوب إلى الله، أو إذا ركبنا رؤوسنا، ومرت المناسبة تلو المناسبة ونحن معرضون مستكبرون، فينبغي أن نتوقع المزيد من الظلم، وتلك هي سنة الله تعالى في الأرض.
من أهم ما يثير الاشمئزاز والتقزز، بل الألم النفسي، أن يذكر مثل هذا الحديث على مسامع كثير من الناس، وبدل أن يستيقظوا إلى ما فيه من عبرة وعظة، يطلقون لعقولهم العنان في التفلسف في معنى هذا الكلام: كيف ترتفع الأعمال إلى الله؟! وما معنى ارتفاعها؟! وهل الله بحاجة إلى أن ترتفع إليه الأعمال؟! وتجد من يؤوِّل ويتشدّق في رفض التصورات الكثيرة في هذا الكلام، واتخاذ ذيول له ما أنزل الله بها من سلطان، بدلا من أن تدخل الخشية إلى قلبه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغمض العين ويقول: صدق الله، وصدق رسول الله، ويحيل تفسير هذا الأمر الغيبي إلى الله، بدلا من أن يقبل إلى الله تائبا نادما يبقى في مكانه، ويطلق لسانه يتمشدق بالتأويلات، يا هذا تحرك بسلوكك إلى الله بدلا من أن تبقى جاثما في مكانك وتتفلسف أمام الناس لتظهر لهم قدرتك الكلامية وفلسفتك الفكرية! نظير ذلك من يسمع عن المكرمات التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الإسراء والمعراج، فيتمشدق قائلا: إنه إنما ارتقى بجسمه الأثيري، نعم، من قال لك هذا؟! في أي آية من كتاب الله قرأت؟! وفي أي حديث من أحاديث رسول الله سمعت؟! ومتى همس لك رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فأنبأك بما لا يعلمه السلف والخلف؟! أمور غيبية نتلقاها من الصادق المصدوق، ثم نكل كيفية ذلك إلى علام الغيوب، هذه ليست من الأمور المادية الخاضعة للتجربة وللمشاهدة حتى نُعمِل بها فلسفتنا فنتسابق إلى ذلك باعتصار عقولنا، لو كان موضوعا خاضعا للتجربة والمشاهدة لتسابقنا، لكنه أمر غيبي، نقول: سمعنا وأطعنا، أسري برسول الله جسدا وروحا، لم يقل صلى الله عليه وسلم (بجسدي الأثيري، أو بغير الأثيري أو نحو ذلك)! ومن ثم فإن هذا الكلام بهذا الشكل المتنطع لا معنى له إلا المباهاة، وإلا العمل على رفع درجات هذا الإنسان أمام الناس، ليزداد شهرة ولتتجه إليه الأصابع بمزية لم تعهد لغيره من الناس، السلوك والانقياد والتذلل إلى الله وعلى أعتابه هو المطلوب.
تسأل كيف يكون نزول الله! أنت! أنت لا تعلم “كما قال الإمام الغزالي “أنت لا تعلم كيف تأكل، أنت شرب الماء لا تعلم كيف تبتلعه، تأكل الطعام ولا تعلم كيف تزدرده! لا تعلم شيئا من طواياك! ثم إنك تريد أن تسلط المناظير على تلك الأحاديث الغيبية، أليس هذا من عمل الشيطان؟!
أقدِّر والله أن جزءاً لا يستهان من المسؤولية لما آل إليه أمرنا يقع على عاتق الدعاة وأصحاب المنابر، وعلى نجوم الدعاة في الفضائيات، الذين ملؤوا الدنيا ضجيجاً وفتناً وفرقة، لا أعمم، ففي الدعاة من هم على خير وبصيرة، لكن حروب المساجد والمنابر بلغت حداً مقلقاً ومفزعاً، ما يستوجب النظر من جديد في كيفية إعداد الدعاة عبر منهج قويم وصحيح بعد هذه الفوضى. ليس غريباً أن يعاقب المحامي أو الطبيب أو المهندس إذا مارسوا مهنهم دون إجازة قانونية، إنما الغريب أن يمارس الدعوة والفتوى من هو ليس لها بأهل ثم لا يحاسب! إن من ملامح الشؤم الذي حل بنا أن تتبدل لغة الدعوة التي هي في الأصل بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، أن تتحول إلى لغة الشتم والقذف والافتراء واللعن والغضب والعنف، ما أدى إلى إحداث الشروخ والفتن بين أبناء الأمة الواحدة، وكل ذلك عبر المنابر الدعوية التي صارت مثيرة للفتنة ومدعاة لإراقة دماء المسلمين. تفرَّق الدعاة في دعوتهم فتفرقت الأمة بتفرقهم، لأنهم (إلا ما رحم ربي) إذا ما استشهدوا بقولٍ قالوا: قال العالم الفلاني والمرجع الفلاني، بدلا من قول الله وقول رسول الله. حتى عند قراءتهم للقرآن وسماعهم له، يكون جل اهتمامهم مصبوباً على حروفه وأحكام تلاوته، وقلما تجد منهم من يهتم بمعانيه وهديه وأسراره وأحكامه.
أسأل الله، مع إطلالة شهر شعبان، أن يردنا إلى دينه وهدي نبيه ردا جميلا، وأن يلهم ساستنا وعلماءنا ودعاتنا الرشاد والتقوى والإخلاص في العمل لوجهه.
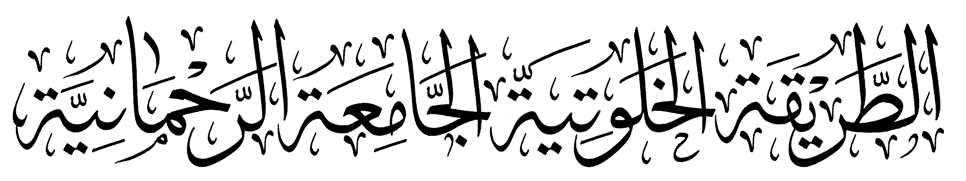 الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية زوايا الاشراف المغاربة
الطريقة الخلوتية الجامعة الرحمانية زوايا الاشراف المغاربة


